جماعة صغيرة اشتهت أن تُعرّض نفسها لأشعة آلامه المقدسة لتحترق فى هذا الموقد – موقد الحب – فتتطهّر مثل الملائكة وتسبّحه بقلبٍ خالٍٍ من الغش، طاب لها المر والخل وقد شبعت من الإسفنجة، نبع لها القوت من ضرباته، وفتحت فاها لتشرب من الدم الذى يجرى منه، وأخذت الماء من جنبه وملأت به بطنها، خبَّأت نفسها فى العش المضفور على رأسه ولم تؤذها الجوارح المتربّصة أتى الصيادون من كل مكان وأحاطوا بها، ضربوها بحجارة الهزء لتفر وتخرج من داخل عشها، رجموها كثيراً وهى لم تسقط على أيديهم، بدأت تُرتل من داخل عشها بأصوات شجية أُنشودة الحُب الإلهيّ، وضعت فمها بأُذني يسوع ورتلت بإيمان قوى وألم عظيم، قالت:
لا تتركنى أفر منك إلى الأشرار، ها جميع الرياح قد هبت علىّ حتى ابتعد عنك ولكننى احتقرتها وصعدت إلى علو عشك، نفخ فىّ قيافا كشبه الحية لكن سمومه لم تقتلنى، وطلب منى حنّان التنين العظيم أن أنزل، لكني رفضت وكنت أؤمن أنَّه لن يصل إلىّ لأنّى فى حضنك أختبئ، ها الشيطان الماكر خرج خلفي لكنه لم يمسكني، لأنَّ ريشى جيد وأستطيع الطيران لأحلق فى سماء حُبّك.
فبينما تنفخ رياح الزور بشدة، اشتعل سراج الأبرار دون أن ينطفئ نور إيمانهم، وحيث تتخبّط الأمواج لتغرق سفينتهم، عبروا البحر بخشبة الصليب ولم يغرقوا، وحيث الإهانات والتعييرات، خرجت الطيور من عشها وطارت، وصعدت إلى فوق بعيداً عن فخاخ الصيادين الأشرار، ووضعت عشها فى إكليل الشوك الموضوع على رأس يسوع لتحتمي هناك فى العش بين الأشواك، فهناك لا تؤذيها أظافر الجوارح لأنَّ من يقترب منها سيُهرق دمه.
من بين هؤلاء أم ابني زبدي، إنّها تريد أن تقدم لابنيها اللذين اشتهت فى يوم أن يجلسا عن يمين ويسار المسيح فى ملكوته مثالاً للأمانة، وقد تعلَّما بحق أن يكونا أُمناء حتى الموت، وأظهرا فيما بعد أنَّهما جديران بأم قديسة طاهرة كهذه .. ولابد أنَّها خاطبت يسوع وإن كانت بلغة صامتة! وهل يحتاج الإنسان إلى لغة ليخاطب عموداً من النور أو جبلاً من البلور؟! فالقلب لا يعرف مالا ينطق به اللسان وما لم تسمع به الآذان!
لقد خاطبها يسوع عن القوة في لحظات ضعفه، ولمّا خاطبها عن المحبة بدمائه ودموعه، شعرت كأنَّ الدم توقّف عن السير، والوجود انحجب واضمحل، وأحسّت بأنَّ صوت لحن سماوي يخترق أُذنيها ويتملك على مشاعرها، فاتضعت روحها أمام نظراته الطاهرة، وأدركت في أعماق نفسها أنَّ الذي تسير بجانبه هو إله وإن كان يرتدي زي البشر!!
ومنذ تلك اللحظات وصورة يسوع ترافقها في وحدتها عندما لم يزرها أحد، وعيناه تنظران إلى أعماقها هي مغمضّة العينين، وقد كان صوته سيداً في هدوء لياليها، وهكذا صارت سجينة حُبّه إلى الأبد، وأدركت أنَّ السلامة في آلامه، والحرية في قيوده، والفرح في دموعه، وإن كان يسوع قد اختفى بعد صلبه عن حواسها، إلاَّ أنَّه اقترب بالروح أكثر فأكثر إلى قلبها! ولكن كيف تركت الأم ابنيها، حليب ثدييها، في طريق ينبوع لم يذق بعد؟! كيف احتملت ولديها، حرارة ذراعيها، يبعدان عنها من أجل بلاد باردة سيذهبان إليها؟!
وبالقرب من أم ابني زبدي كانت تسير مريم أم يعقوب ويوسى، وقد صار لها الشرف هى الأُخرى أن ترى ابنيها ضمن رفقاء يسوع يُحدّثون بعجائبه ويتكلّمون بأمثاله الحيّة وتعاليمه المُحيية، فقد كانت قوة خفية تُرافق كلماته فتستأثر القلوب، وتُزيل الصدأ من معادن النفوس، لأنَّه كان ينسج أمثاله وقصصه من خيوط الفصول وإليك مثالاً من طريقته:
" خرج الزارع ليزرع "، أو " كان لرجل غني كرم " أو " راعٍ عد خرافه "، فكلمات مثل هذه لابد أن تؤثر في سامعيه، لأنَّ كلنا عند التحقيق زارع، وجميعنا نُحِب الكرمة، وفي مراعي ذكرياتنا راعٍ وقطيع وخروف ضال وهناك أيضاً محراث ومعصرة وبيدر..
لقد عرف يسوع نوع الخيوط الذي صنع الخالق منها ثوب حياتنا، ولهذا استطاع أن يخترق بتعليمه الإلهية أعماق قلوبنا، ولأنَّه رأى الحياة بنور الله الذي هو أنقى من نور عيوننا، خاطب مشاعر البشر لا عقولهم، وعواطفهم لا أفكارهم فقط، أمّا كلامه فقد حمل قوة لم تصل إليها حكمة الفلاسفة، وكثيراً ما كان في كلماته يمتزج صوت البحر والريح وصوت الأشجار والنسيم والورود.. فإذا تكلّم كأنَّ الحياة تتكلّم مع الموت!
لقد كانت مريم تمشي بين الجمع كأنَّها روح انفصل عن الجسد، تتوجّه حيثما توجه، وإن سقط كانت تبكي بمرارة، ولأنَّ عظامها كانت من صُلب النحاس فهي لهذا لم تنثنِِ، وكانت عيناها كالسماء اتساعاً وشجاعة، فلم ترهب الجند أو الكهنة الذين ترأوا لها كأطفال! فصارت رمزاً للوفاء، وقد تمنت أن تموت لتُعطي حياتها للحياة الذي مات لأجلها، ولو استطاعت لحاكت من خيوط حُبّها ثوباً لتستر به عرى يسوع، الذي أحبّته وأحبّها، فعادت إلى بيتها وقد جلست إلى نولها لتصنع ثوباً لم تلبسه، لأنَّه لابنيها قد صنعته، إنه ثوب الشجاعة والوفاء.
وها هى مريم المجدلية التى أخرج منها الرب سبعة شياطين، تنتحب فى صراخ شديد وتريد أن تتقدم لتُقبّل وجه الحبيب، ولكنَّها خافت من الذئاب البشرية المحيطة به، أو قل تجنبتهم إلى أن تنتهي مأساة الصليب.
لقد كانت المجدلية إنسانة ميتة، ملعونة من السماء والأرض، أذلتها شياطين الشر، وأيضا شياطين البشر، ولكن لمّا نظر فجر عينى يسوع إلى عينيها غابت جميع كواكب الشر من ليل حياتها المظلم، لأنَّ حب يسوع ذبح الوحش الذي كان يسكن أعماقها، فصارت امرأة فاضلة، قدمت ذاتها بخوراً طاهراً لإله الحُب، ولكن حكمة مريم قد تجلت عندما احتضنت حُبه في قلبها، فما الذي دفعها إلى حُبه؟ هل مجاعة عينيها الراغبة في الجمال، أم جماله الذي يفتش عن النور في عينيها؟
إن يسوع استطاع أن يدخل إلى هيكل المجدلية، وقد رأى الأرواح الشريرة التي تتآمر عليه وعليها، كما رأى الأرواح الطاهرة، التي تغزل خيوط الحُب بين البشر، ولكن الطريقة التي اتّخذها لشفاء المرضى لم تكن معلومة لدى أطباء وفلاسفة البشر، فقد كان بكلمة يأمر الشياطين أن تخرج فتفر هاربة! لقد عرف المسيح الفولاذ الصحيح تحت الصدأ؟!
أمَّا مريم أم مُخلّصنا فكانت تسير فى خطوات هادئة من شدة التعب، وهى تُغطي وجهها الذابل من الحزن، وكانت تتفرس فى ابنها وهى متوجّعة القلب، لقد بلغها رمح الألم كما قال لها سمعان الشيخ يوم ميلاد يسوع: " وَأَنْتِ أَيْضا ًيَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ " (لو2: 35)، عبر الحزن فى نفس الأم الطاهرة على وحيدها، ولم تقدر أن تتقدّم إليه عندما كانوا يستهزئون به، فصرخت فى قلبها ولم تفتح فاها لئلا يسمع أحد رعد ألمها.
لقد عجزت الأم أن تُخفف آلام ابنها، فما وصل إليه من الإنكار يؤلمها كما يؤلمه، وما احتمله من عذابات حملته هى فى قلبها! لقد كانت عيناها عالقتين به لا تتحولان عنه، كما كانت عيناه الداميتان لا تتحولان عنها، لم يتكلما معاً ولكن كم من أشياء تخاطب بها قلباهما الحزين فى ذلك اللقاء؟! ويبقى السؤال الحائر: كيف احتملت الحمامة الوديعة أن ترى ابنها الوحيد وهو بهذا المنظر العجيب؟ لابد أنها كانت تعرف أن فى عذابه وموته حياة للناس أجمعين !
لقد ولدت مريم بكرها شجيرة صغيرة، وكانت تُراقبه بعيون المحبة لأنَّه كان ممتلئاً بقوة الحياة، ومرت الفصول وغابت أقمار وشموس.. فصار الطفل صبياً ينمو كالنخلة في أرضنا القفرة، وعندما بلغ شبابه صار جميلاً كالربيع وكانت عيناه كالعسل ممتلئتين من حلاوة الحياة، وكان على فمه عطش قطيع الصحراء لبحيرة الماء، فهو يريد أن يُعلّم الناس لكي يجتذب إليه أبناءً للملكوت وكانت فصاحته تسمو على قلوب البشر الصامتة، التي كانت تحن إلى تعاليمه كالحنين إلى ضياء النجوم، فما الذي حدث للربيع فتحول فجأة إلى خريف ؟! ما الذي جعل الظلام يطبق بسحابته على النهار ؟!
إنني أرى مريم وقد تضخم قلبها بدماء الألم، لقد كان حزنها على ابنها شديداً، فكانت تُحدّق فيه طويلاً ثم ترفع وجهها إلى أعلى فتتأمل السماء البعيدة منذهلة، وكأنها ترى رؤى سماوية، وقد كان بينها وبين صالبيه، بين قلبها وقلبهم أودية عميقة، أو قل صحراء واسعة من الحزن والألم، لكنّها لم تكن تخشى ظلام الأشرار، لأنَّها كانت تؤمن أنَّ الليل وأشباحه لن تطول إقامتهما معها لأنَّ صباح القيامة قريب، ولهذا مشت مريم وراء ابنها برأس مرتفع، وعندما وصل الجمع إلى الجلجثة ورفعوا يسوع على الصليب، لم يكن وجهها حزيناً بل كان أشبه بمنظر الأرض المثمرة، التي تلد أولادها بغير انقطاع وتقبرهم بلا ملل، طالما أنَّ في موتهم حياة لآخرين، فمريم التي كانت في ربيع حياتها ترأت لي شيخة طاعنة في السن، لأنني رأيت حصاداً في أزهارها وأثماراً يانعة في ربيعها!
يُخّيل إلىّ أن مريم كانت تناجي روحها فخراً بابنها الحبيب، فكانت تقول: أيها الرجل البار، الشجاع الكامل، الذي زار بطني مرّة، لم ولن تتكرر في البطون، أؤمن أن كل نقطة من دمك الطاهر المتساقط ستكون ينبوعاً، لأنَّ منها ستتكون أنهار الحياة الروحية لأمم وشعوب، أنت الآن تموت في هذه العاصفة، ولكني لن أحزن عليك أكثر من هذا لأنَّ في موتك حياة لكثيرين..
أما يسوع فنظر إليها وابتسامة هادئة تعلو شفتيه، وقد كانت هذه الابتسامة دليلاً على أنه قد غلب العالم، فرفعت مريم عينيها نحو السماء وقالت: أُُنظروا الآن، لقد انتهت المعركة، وأعطى الكوكب نوره، قد وصلت السفينة إلى الميناء، ويسوع الذي اتكأ على قلبي الآن يتموج في الفضاء، لقد غلب العالم، ويسرني أن أكون أمَّاً للغالب، ثم رجعت إلى أورشليم متكئة على ذراع يوحنَّا الحبيب، كما لو كانت قد حققت كل آمالها في الحياة!
إنَّها مثال للأم التي تموت لتعطي الحياة لغيرها، تحوك من الخيوط ثوباً لن تلبسه، تلقي الشبكة لتمسك السمك الذي لن تأكله! لقد بكت ورنَّمت، سكبت دموع الحزن ولآلئ الفرح، لأنَّها كانت هى الأخرى في حاجة إلى الخلاص.. فهل رأيت عصفورة ترنم وعشها في الهواء يحترق!
وكان هناك فى طريق الصليب يوحنَّا الحبيب، الذي وهو فى حاجة إلى تعزية، يحاول أن يشدد أم ربّه فى أحزانها، إنَّه التلميذ الوحيد الذى كان يسير فى طريق الصليب، فالرجال هربوا وبقيت النساء، فأين توما الذي قال: " لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضاً لِكَيْ نَمُوتَ مَعَهُ؟ " (يو16:11)، وأين بطرس الغيور الذى قال لمعلمه: " وَإِنْ شَكَّ فِيكَ الْجَمِيعُ فَأَنَا لاَ أَشُكُّ أَبَداً.. وَلَوِ اضْطُرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ! " (مت33:26،35) لم نرَ أحداً لا هذا ولا ذاك حتى الذين أقام موتاهم أو فتح أعينهم أو شفاهم.. أنكروا الجميل وتملّك عليهم الجبن، لكي تتم نبوة إشعياء النبى: " دُسْتُ الْمِعْصَرَةَ وَحْدِي وَمِنَ الشُّعُوبِ لَمْ يَكُنْ مَعِي أَحَد" (إش3:63).
إنَّ هذا القطيع القليل فى عدده والكبير فى محبته، يُعلن لنا أنَّ المحبة نحو المُخلّص المتألم، لم ولن تنقرض من على الأرض، وفى هذه الجماعة الباكية نرى البذور التى دبّت فيها الحياة بلمسة هذا المصلوب، والتى أنبتت فى المستقبل مملكة عظيمة، تتبع ملك الملوك الذي عُلق على الصليب!لقد صاروا كعصافير صغيرة، نثروا حبوبه المقدسة التي وضعها في أيديهم، نثروها على القلوب لكي تنمو وتفيض على الأمم من ثمار الروح التي هى: محبة وفرح وسلام فيشبعوا ولا يلجأوا إلى تجار العالم الذين يخلطون الحق بالباطل، وطعامهم المغشوش قد سم كثيرين.













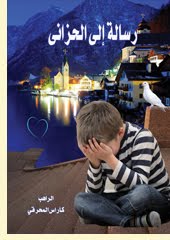






















































































































ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق