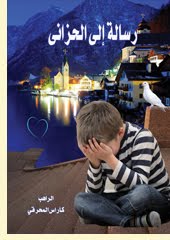لاشك فى أن الانحلال الخُلقى، الذى اشتعلت نيرانه وغزا نواحى كثيرة من حياتنا، أضاف إلى جروح الإنسان جرحاً ما أشد ألمه! لقد صار الجنس إله هذا العصر، وما أكثر الذين سجدوا له وسقطوا تحت أوهامه، فمعظم المطبوعات اليوم، الأفلام هى عن الجنس، حتى وسائل الدعاية أصبحت هى الأُخرى تعتمد على الجنس، وما هذا إلا إعلان أن الناس فقدوا هدفهم فى الحياة، بل إرادتهم وإيمانهم، وأصبحوا يتحركون فى دائرة بلا مركز أو محيط ثابت.. فالسعى وراء الجنس هو بداية النهاية، ولهذا قال أحد مؤرخى الغرب: إن الانحلال الخُلقى سيدمرنا لو لم يدمرنا الشيوعيون.
لقد تورط المجتمع الغربى فى الجنس وامتلأ به، بحيث أصبح يسيل من مسام حياته، فأصبحت اللذة هى الهدف الوحيد الذى ينشده ملايين البشر، وأصبح المذهب المسيطر الآن هو مذهب المتعة، فكثرت الكتابات المنحرفة، والأفلام المثيرة.. ويبقى السؤال الحائر: هل الحرية أن يعيش الناس فى الفساد ؟! ثم ما هى نهاية الانغماس فى الجنس ؟! ألم يؤكد معلمنا القديس بطرس الرسول، إن الحرية لا يجب أن تكون سترة للشر (1بط 2: 16) ! قد نكون على صواب لو قلنا: إن الحريـة الحقيقية هى: أن أفعل ما يجب لا ما أريد.
إن الانغماس فى الجنس لا يولد سعادة كما يظن البعض، بل عذاباً نتيجة الشعور بالذنب والصراع الداخلى المرير، وبعد قليل يجد الخاطئ نفسه مصاباً بأمراض نفسية وجسدية.. وشخصيته قد تعطلت واُحبطت مساعيها فى البحث والنمو، وتصبح شهواته شهوات انفلت زمامها، ومن المستحيل السيطرة عليها، ولا عجب فى هذا، لأن من يتحدى قانون الطهارة الإلهى يعيش فى توتر دائم، ومن يبحث عن نشوات جديدة واختبارات مثيرة، يكون دائماً فى قبضة الخوف والشك والقلق.. وينظر للآخرين كما لو كانوا موائد شهية، يقترب منهم عندما يشـعر بحاجته للطعام، أما النفوس فتظل بعيدة كخدام أذلاء.
وليس الجنس وحده هو ثمرة الانحلال الخُلقى، وإنما انهيار العلاقات الزوجية، ورفض القوانين والمبادى الأخلاقية، وتلف عقول الملايين بسبب إدمان المخدرات وتعاطى المسكرات، وتمرد الأولاد على والديهم، كل هذه مظاهر للانحلال الخلقى، وقد زادت من جروح البشر وأكثرت من نزيفه.
أيضاً الحروب جرحاً كان ولا زال يؤلم البشر فالحروب التى مضت لا زالت تؤرق حياتهم، والحروب القائمة تُقلق ضميرهم، فرائحة الهواء حتى الآن مفعمة بالحقد التاريخى وصراعات الشعوب، ولا زالت قصص المذابح والحروب.. التى تنشرها الصحافة تثير الرعب والفزع فى قلوب الكثيرين.
إن الحرب ما هى إلا مظهر من مظاهر العنف بل قمة أعمال العنف التى تجرح الإنسان وتمزق الروابط بين البشر، وتُدخل الحقد والكراهية فى قلوب الجماعات، يكفى أنها تفقد الإنسان سلامه، وهل يمكن لإنسان أن يحيا بلا سلام! لقد قامت حروب كثيرة، وحتى الآن لم تتمكن منظمة دولية أو هيئة دينية فى وضع حد لها، ولعل السبب هو عداوة الإنسان لأخيه الإنسان، فالإنسان منذ أن سقط امتلأ قلبه بالحقد والكراهية والغيرة.. وإلا لماذا قتل قايين أخاه هابيل ؟!
كما أن للطمع دوراً خطيراً فى انتشار الحروب، فالإنسان شره للمال وكلما اغتنى طلب المزيد، فمن المعروف أن سلم الطمع لا نهاية له، فكلما ارتقى الإنسان درجة نظر الى الأبعد، أما الدرجة الأعلى فى سلم الطمع ليست إلا سراباً خادعاً أو وهماً كاذباً !
هذا عن الحروب الدموية، أما الحروب العلمية والدينية فلها أيضاً جروح، فالعلم الذى جعل الإنسان يسبح فى الفضاء ويغوص فى أعماق البحار، وأعطى له الطائرة والسيارة والكمبيوتر.. هو أيضاً الذى أعطاه القنبلة الذرية، التى أنزلت الموت والألم على هيروشيما.
وهناك وثائق تؤكد أن الحرب الجرثومية والكيميائية ستتحكم فى مصير كوكبنا قبل نهاية القرن الحالى، فما أكثر الجراثيم التى يمكن أن تقضى على أمة بأسرها، وما أكثر الفيروسات التى لها قدرة على إحداث انهيار صحى شامل فى قارة بأكملها !
أما الأديان فلازالت حروب تُقام ودماء تُسال باسمها، وها نحن نتساءل: هل يرضى الله القدوس بأنهار الدماء التى تُسال من أجـله وباسم الدين ؟! وكأن مهمة الله أن يحيى الأموات، ومهمة الإنسان أن يميت الأحياء!
وهل ينكر أحد أن الخوف مزق كيان البشر، فالخوف جرح له جذور منذ القدم، وعلى الرغم من أن المسيح سعى ليحرر الإنسان من قيدين هما: الخوف من السماء والخوف من الأرض، إلا أنه لا زال يحيا خائفاً، ويبقى السؤال الحائر: كيف ينمو مجتمع ويتقدم حضارياً، وقد ملأ الخوف قلوب شعبه؟!
فالخوف سم قاتل للحياة والتقدم، والإنسان الخائف لا يمكن أن يُبدع، أو يُطلق ما فى وجدانه من أحاسيس، والعقل الخائف المتردد حتماً سيُصيبه الشلل، وينطفئ فيه نور الحكمة والمعرفة..
أما الخوف من السماء، فقد تسرب سُمه فى كيان الجنس البشرى عن طريق كهنة الأمم، الذين صوّروا الله جباراً قاسياً منتقماً، إذ كانت فكرتهم عن الله أنه أعظم مخيف، والإنسان ما هو إلا عبد ذليل، مخلوق ضعيف، ولهذا سـجن الكهنة القدماء الإنسان فى دائرة محرمات، وأرعبوه بفكرة جهنم والنار الآكلة، فتحول الله فى نظر الأقدمين إلى أُسطورة، كما لو كانت خيالية ولكنها تبث الرعب فى النفوس.
نعم لقد أزلت طبقة الكهنوت الناس بتخويفهم من الله والسماء، بعد أن ظنوا أنهم أمسكوا بمفاتيح الجنة والنار، يُدخلون ويُخرجون من يشاؤون! أما نتائج هذا الإذلال فكان امتصاص أرزاق البسطاء وعامة الشعب، تحت ستار بناء الهياكل والمعابد، وما كان هذا التسخير إلا لبناء أنفسهم لا لبناء المعابد كما كانوا يدعون!
فى أوقات السلم كان على الشعب أن يعطوا الكهنة نصيبهم، وفى أوقات الكوارث يدفع الشعب الأموال لتقام الصلوات، حتى تكف الآلهة عن الغضب والانتقام، فتحول الإنسان إلى عبد مطحون فى دنياه، خائف ذليل أمام آخرته، وتحولت فكرة الله إلى شبح مجهول لا يُرضيه إلا الذبائح والتقدمات، وانتشرت الأساطير والخرافات وقصص الجن، وساد نفوذ السحرة والمنجمين، واُقيمت حواجز وسدود بين الإنسان والله، إلى أن جاء السيد المسيح وحرر الإنسان من خوف السماء، الذى قيده به رجال الدين، وفتح أبواب السماء على مصراعيها، ونادى بأن كل مؤمن هو ابن الله، كما علّمه طريق الاتحاد بالله، وأعلن له أن ملكوت الله فى داخله " ها ملكوت الله داخلكم " (لو21:17).
هذا عن خوف الإنسان من السماء، أما خوفه من الأرض فله أيضاً جذور، فقد مرت على البشرية فترات حاول فيها بعض البشر تأليه أنفسهم، والويل لمن لا يسجد لهم أو لمعبوداتهم، فمن طبيعة البشر فرض النفوذ، ومن طبيعتهم أيضاً الخوف من القوة، فهذه آفة ورثها الإنسان عن مجتمع الغابة وعصور الجهل والظلام !!
لكن المسيح كما حرر الإنسان من خوف السماء، حرره أيضاً من استبداد البشر، عندما نعت هيرودس الملك بالثعلب، وسمى الفريسيين بالحيات أولاد الأفاعى، وشحذ فكر رؤساء الكهنة والكتبة حرّاس شريعة موسى، وأمسك سوطاً وهو إنسان فقير يحيا فى أسرة فقيرة، لا يحمل سلطة ولا يؤيده قانون وضرب باعة الحمام وقلب موائد الصيارفة..السوط الذى أرعب البشرية يمسكه المسيح لا ليجلد البشر بل روح الوثنية وشبح المادية، ويطرد روح الشر من هيكل الله.. وهكذا زلزل ابن البشر فى ثورته العارمة كل أركان الأمة اليهودية فتلعثمت قلوبهم، واضطربت سيوفهم، وخجل قوادهم وعلماؤهم، وهرب التجار والعبيد والحراس.. ولم يجسر أحد أن يتصدى له أو يرد عليه أو يدنو منه.
لأن من يجعل كتب السماء شبكة، يصطاد بها أموال البشر هو خائن لشريعة السماء، ومن يقلده المؤمنين سلطة فيمتشقها سيفاً ويرفعه فوق رؤوسهم مراءٍٍِ، ومن يسلمه الضعفاء أعناقهم فيربطها بالحبال، ويقبض عليها بيد من حديد وأخرى من نار.. ولا يتركها حتى تنسحق وتتبدد كالرماد ظالم، هو ذئب كاسر! يدخل الحظيرة فيظنه الراعى خروفاً وينام مطمئناً، وعند مجئ الظلام يثب على النعاج ويخنقها، وهو نهم يحترم موائد الطعام أكثر من مذابح الهيكل، محتال يدخل من شقوق الجدران ولا يخرج إلا بسقوط البيت، ولص صخرى القلب، ينتزع الدرهم من الأرملة والفلس من اليتيم !
الإنسان مجروح أيها الأحباء، لأنه عطشان إلى شئ عظيم اسمه الحرية! التى أصبحت مجرد كلمة نسمعها ونقرأ عنها، ولكن لا يعيشها الكثيرون.. كلُنا نرى العصافير فوق أغصان الشجر، وهى تتراقص فوق الأوراق، فى سعادة غامرة لا تبالى بما يحيط بها، ولكنها تقفز فى غير خوف أو قلق، لست أعرف عنها شيئاً لكنى أُدرك أن الحياة تسرى فى كيانها، وأن حيوية غامرة تتدفق فى هذه الكائنات الصغيرة الضعيفة وأن قوة تمدها بهذه الحياة، وأدرك أيضاً أن كل هذا إنما ثمرة من ثمار الحرية... لا ننكر أن فلسفة جديدة شقت طريقها فى عصرنا، تدعو إلى استقلال الفرد ذاتياً، فالنضج الروحى ينمو فى كل مكان، نضج يتفهم أهمية العدل والمساواة والحرية.. فقد أصبح الآن واضحاً أن الحياة لا تزدهر إلا فى الإنسان الحر، الذى يملك فكره، ويسيطر على ذاته، ويقود خُطواته.. ولكن حتى الآن لم تزل شعوب ترزح تحت قيود الذل والعبودية.. فبعد تحررها من عبودية الاستعمار ، رزحت تحت عبودية الفقر والجهل والتعصب.. تحررت الشعوب من قيود الأمم القوية الغنية ورزحت تحت أغلال السخرة الاجتماعية والنفسية.. وهى بلا شك قيود ما أصعب فكها! وجروح ليس من السهل تضميدها!
لقد حصلت شعوب كثيرة على الحرية، لكنها للأسف الشديد لم تحصل على عالم أفضل كما كانت ترجو! وما تزال الصحف تنقل إلينا صوراً أكثر عن الظلم والاستغلال والرياء.. بصورة تضاهى بل تفوق أحياناً ما كان يجرى فى أيام الملوك المستبدين، وهاهى تحيا فى نكسات سياسية واقتصادية واجتماعية.. إن احترام المجتمع لحرية الفرد، قانون إلهى وليس منحة أو هبة يمنحها إنسان لآخر والعدالة كما يقول سقراط الفيلسوف : ليست منحة من القاضى وإنما هى حق للمتقاضين عليه أن يوفرها لهم، أما حياة الإنسان فهى دعوة إلهية خاصة به، ولا معنى للدعوة الإلهية إذا سلبناها الحرية، والويل لمن يحتقر إنساناً ويحاول أن يذله ويسلب حريته أو يكبح النار الإلهية المقدسة المشتعلة فى وجدانه.
كل المجتمعات التى احترمت حرية الإنسان، ورفعت من شأنه، تقدمت وازدهرت حضارتها، وأبدع أُدباؤها وفنانوها ومفكريها.. أما الذين داسوا على كرامة الإنسان واحتقروا آدميته، وقتلوا حريته، عاشوا فى ظلام لايعرفون شيئاً فى الحياة، سوى إشباع رغباتهم المشتعلة وعواطفهم المضطربة! ويبقى السؤال:كيف يمكن لمجتمع أن ينمو ويتقدم، وقد تحول شعبه إلى قطيع، قُطعت عنه سُبل التفكير، واُلغيت شخصيته، وكل النظرات توجه إليه على أنه عبد ذليل!!
أما الجرح الأعظم فى حياة الإنسان، هو عدم معرفته لله معرفة حقيقية، فرغم انتشار الثقافة، واتساع الكرازة، ونمو الوعى الدينى، إلا أن كثيرين لم يخلصوا فى علاقتهم بالله! يجب أن نعرف أن الله خلق الإنسان وكوّنه، بحيث أنه لا يقدر أن يعيش بدونه، فنحن كما قال القديس أُغسطينوس: " خرجنا من عند الله، وستظل أرواحنا هائمة إلى أن تلتقى بالله ".. ولهذا مهما امتلك وتمتع.. فلا بد له من الله.
قال أحد الأدباء
" إن السماء تبكى بدموع الغمام .. ويخفق قلبها بلمعان البرق .. وتصرخ بهدير الرعد، وإن الأرض تئن بحفيف الرياح .. وتضج بأمواج البحر، وما بكاء السماء ولا أنين الأرض إلا رحمة بالإنسان ".
فياليتك تبكى كلما وقع نظرك على سخص متألم أو إنسان مجروح ، فتبتسم سروراً ببكائك.. واغتباطاً بدموعك.. لأن الدموع التى تنحدرعلى خديك فى مثل هذا الموقف هى حبات لؤلؤ أو قل: سطور من نور.. تسجل لك فى صحيفة الحياة البيضاء: " إنـك إنسـان ".