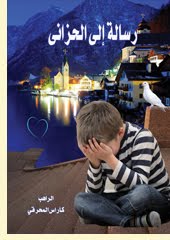من الاسم نستطيع أن نعرّف الوسائط الروحية بأنها: الوسائط التي عن طريقها نستطيع أن نحصل على النعم الإلهية، فالصلاة، الصوم، الاعتراف، التناول، القراءة ... كلها وسائل أعطاها لنا الله، لكى ننال من خلالها بركات روحية.
وهى بهذا تقوينا في الحياة الروحية، وتساندنا في جهادنا، لا ضد البشر والشيطان فقط، بل وضد الذات نفسها، التي هى أكبر وأخطر عدو للإنسان! فإن أهمل الإنسان الوسائط، لا يكون قد عصي الله فقط، بل وأضر بنفسه أيضاً!
إن الوسائط الروحية هى ثدي حي منه نشرب حليب النعمة الإلهية، فنتغذى وننمو، ويتقوى إيماننا ونثبت فى الإيمان والرجاء والمحبة...
ألا يحتاج الجسد إلى طعام ليحيا، ألا تحتاج الشجرة إلى ماء لتنمو؟ وهكذا الروح إن لم ترتوِ بالله من خلال وسائط النعمة، فلن تنمو فى أى شىء روحانى!
ولهذا يخطىء من يظن أن الوسائط يمكن الاستغناء عنها، أو أنها ضرورية للإنسان فى بداية حياته الروحية فقط، ألم يقل رب المجد " مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ " (يو56:6) فكيف نثبت فى الرب بدون تناول ؟! وكيف نعرف أن هذا خطأ وذاك صواب.. إن لم نقرأ فى الكتاب المقدس؟!
نستطيع أن نشبه الوسائط الروحية بالأسلاك، التى توصل إلينا تيار الروح القدس، أو النبع الذى عن طريقه يصلنا ماء الحياة العذب، فإذا قُطعت الأسلاك توقف التيار وساد الظلام، وإذا إنسد النبع لا يصلنا الماء، ونحن نعرف إنه حيث لا ماء لا حياة!
ولعل أجمل ما فى الوسائط، إنها تجعل الإنسان فى لقاء دائم مع الله، وفى مثل هذه اللقاءات الروحية، يظل الشيطان يجول هنا وهناك حائماً حول رأسك، ولكنه لا يجرؤ أن يقتحم غرفة مسكنك، وإن تجرأ فسرعان ما يتركك، لأنه لن يجد مكاناً يعشعش فيه سواء فى رأسك أو قلبك.
يقول إرميا النبي: " مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَّكِلُ عَلَى الإِنْسَانِ" (إر5:17) إذن كل من يسير في طريق الروح بدون وسائط النعمة، يكون كمن يتكل على ذراعه البشري، ولهذا لم نسمع أن مؤمناً أهمل ممارسة الوسائط، إلا وفترت حرارته الروحية، وتعرّض لمحاربات خطيرة، وسقطات كثيرة لعل أهمها الكبرياء!
ولهذا فإن أول حرب يشنها الشيطان على المؤمنين، هي محاولة إبعادهم عن الينابيع الروحية، التى هى مصدر حياتهم أعنى خلاصهم، لأنه بهذا يبعدهم عن الله بصورة غير مباشرة، ويصيبهم بشلل روحي، حينئذ يستطيع أن يلعب بهم كما تلعب القطة بالفأر!
إننا نخطئ كثيراً عندما نهمل الوسائط الروحية، ونخطئ أيضاً عندما نمارسها بطريقة روتينية، جافة، إذن المهم ليس هو ممارسة الوسائط فقط، بل وأيضاً طريقة ممارستها، ولو أخذنا الصلاة على سبيل التوضيح نقول:
إن الصلاة الحقيقية هي حديث عذب مع الله، يملأ القلب بالأفراح الروحية، ويزيده شوقاً إلى الحياة السمائية، هي غذاء حي للروح، سياج لكل فضيلة، بل هي الأساس الذي فوقه تبني كل فضيلة، ولا يوجد مجرى أوسع من هذه القناة، التي تفتح لنا بسهولة باقي مجاري النعمة الإلهية.
ولكن ماذا لو تحولت الصلاة إلى مجرد ترديد ألفاظ، أو ذبذبات هوائية تخرج من أفواهنا بلا حرارة روحية ؟! أعتقد أن القديس مار إسحق كان مختبراً عندما قال: ما وقفت قدام الله لأُعد ألفاظاً، بل البلوغ إلى المساكن العلوية.
والصوم ليس هو الامتناع عن الطعام الحيواني والاكتفاء بما هو نباتي، لأن هذا لا يمكن أن يقرب الإنسان إلى الله، ولا يعطيه نقاوة تليق بخالقه كما قال القديس صفرونيوس، إنما الصوم فى مفهومه الروحي، هو منع النفس عن كل شهوة كما مُنع الجسد عن الأطعمة الحيوانية، واتخاذ أيام الصوم فترة مقدسة للصلاة والاعتراف والتناول والنمو الروحى...
أيضاً القراءة، فى الكتاب المقدس، أو كتب الآباء، أو الكتب الروحية.. ليست هى مجرد وسيلة لجمع أو تحصيل المعلومات، فالكمبيوتر يستطيع أن يمدك بكل ما تريد من معلومات، إنما الهدف الأسمى للقراءة، يجب أن يكون تحويل المعلومات إلى حياة، واتخاذ المعومات مادة للصلاة والتأمل وشغل الفكر بالله...
إن الهدف الحقيقي من قراءة الإنجيل هو أن نغذى حبنا للمسيح، وأن نشغل قلوبنا بآيات مقدسة للدخول في الصلاة، ولكي يزودنا الكتاب المقدس بالإرشاد فى حياتنا الشخصية والروحية..لأن وصايا الله مدرسة، قد أُرسلت إليها لتجلس على مقاعدها، وتتعلم من حِكمها دروساً تحكمك إلى الأبد، فلا تتركها قبل أن تتخرج وتحصل على شهادتك منها.. هى منجم جدرانه مرصعة بالأحجار الكريمة، فلا تخرج دون أن تحصل على عينات ثمينة منه.. حديقة يتمشى الرب فيها، وأشجارها محملة بالبر والسلام، فلا تترك هذه الجنة دون أن تجنى أثمارها!
ألم يقل معلمنا داود النبى: " مَا أَحْلَى قَوْلَكَ لِحَنَكِي! أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ لِفَمِي " (مز103:119) إذن فالوصية لم تعطَ للإنسان إلا لراحته، ومن هذا المفهوم يستطيع أن يحيا سعيداً إن أراد وعمل بها، فالله قد وضع وصايا كثيرة، ووصاياه ليست ثقيلة، إن أطاعها عاش فى سلام، وإن خالفها عاش فى ألم وشقاء.
والحق إنني لا أكتب مجرد نظريات فلسفية، تصلح أن تكون مادة للنشر، إنما أكتب عن خبرة شخصية عشتها، إذ تعلمت كثيراً من كتب قرأتها، وأرسل لي الله رسائل من خلال آيات إنجيلية أو كتب روحية..
فقد مرت علىّ فترات شعرت فيها بأني مكتف بما أنا عليه من ممارسات روحية، ولكن حدث بينما كنت أقرأ في كتاب أن وجدت عبارة بلغة تقول: إذا شعرت أن نموك قد توقف فأعلم أنك في حاجة إلى مساعدة آخرين! فما أن طلبت المساعدة، حتى مارست أضعاف ما كنت أمارسه من صلوات وقراءات..
كما أن التناول يجب أن يكون بإيمان كامل، أن الخبز يتحول إلى جسد المسيح وهكذا الخمر إلى دمه الذكي الكريم، وإلا شابهنا الوثنين!! ولو أننا نتناول خبزاً وخمراً فما الذي دفع بولس الرسول أن يقول: " أَيُّ مَنْ أَكَلَ هَذَا الْخُبْزَ أَوْ شَرِبَ كَأْسَ الرَّبِّ بِدُونِ اسْتِحْقَاقٍ، يَكُونُ مُجْرِماً فِي جَسَدِ الرَّبِّ وَدَمِهِ " (1كو27:11 )!
وهل يُعقل أن الكنيسة تقيم الصلوات والتسابيح من نصف الليل - كما فى الأديرة - وتعلّم الناس وتهيأهم للتناول عن طريق الرسائل والإنجيل والعظة، ثم تعطيهم فى النهاية خبزاً وخمراً! أليس في استطاعة كل إنسان أن يأكل خبزاً ويشرب خمراً في بيته!