
منذ القدم والإحساس بقدرة الإنسان على مواجهة العواصف العاطفية يُعد فضيلة تستحق التقدير، لأنَّ ضبط النفس الذي يحقق التوازن العاطفي يقود الإنسان إلى حياة سوية.
صحيح أنَّ كثيرين لا يقدرون على تحمّل الألم، الناتج عن ضبط العواطف المزعجة، ولهذا سرعان ما يقعون فريسة تحت تجارب العواطف القاسية، فتنهار مبادئهم، وتضعف شخصياتهم، وحينما تزول الضيقة عن الإنسان الضعيف، فإنَّ العاطفة الجامحة تترك فيهم تشوّهات خلقية ونفسية، فيجدون أنفسهم عاجزين عن الوقوف على قدميه.
وعلى العكس من ذلك، نجد أن الرجل الذي يتصدى لبركان العاطفة الطاغيّ، لا يخرج من حربه إلاَّ أقوى صلابة، وأشد عزيمة، وأصلب عوداً، فالتجارب لمثل هذا تكون فرصة لزيادة قدرته على التحمّل، وتنمية أخلاقه، وتنقية معدنه الإنسانيّ.
لا شك أنَّ مفتاح سعادتنا يكمن في ضبط عواطفنا المزعجة، التي تفقدنا سلامنا واستقرارنا، ولكن يجب أن نعترف بأننا مهما ضبطنا انفعالاتنا فلا بد بين الحين والآخر، أو على غفلة يتسلل إلينا بعض الانفعالات الخبيثة، لأنَّ السعادة الدائمة أمر مستحيل وهى أشبه بالابتسامة المفتعلة لا يمكن لها أن تدوم.
والحق إنَّ معظم البشر يقفون على خط الوسط العاطفيّ الرماديّ، الذي يفصل بين الأبيض والأسود، مع بروزات خفيفة من الانفعالات الحادة عبر طريق حياتهم، ومع ذلك تستغرق مهمة إدارة عواطفنا كل أوقاتنا، فكل ما نفعله خاصة في أوقات فراغنا هو محاولة السيطرة على حالتنا النفسية، ومعروف أنَّ فن التخفيف عن النفس مهارة من مهارات الحياة الأساسية.
ويرى البعض أنَّ تركيب مخ الإنسان يجعله غير قادر على السيطرة على انفعالاته متى جرفته، ولكنّه يملك السيطرة على الوقت الذي يستغرقه أي انفعال، وإن كان البعض قد استطاعوا السيطرة على انفعالاتهم وأفكارهم، فهؤلاء قلة نادرة، ولم يصلوا إلى هذه الدرجة بسهولة!
ولكن ما الذي يحدث للإنسان عندما تضطرب عواطفه ولا يقاوم مثل هذه الانفعالات القاتمة؟ أعتقد أنّه إمَّا أن يلجأ إلى المبالغة في الظهور أو انتقاد الآخرين أو تبرير النفس أو عدم الاعتراف بالفشل، وهناك من يلجأ إلى احتقار الذات، أو الانزواء واعتزال المجتمع أو المبالغة في العمل من أجل نسيان الواقع المؤلم..
إنَّ المؤشرات السلوكية التي تظهر في حياة الإنسان عندما تضطرب عواطفه كثيرة، لكن أهمها هو الآتي:
الاكتئاب
إنها حالة يشعر فيها الإنسان بشيء من الغم أو عدم الرضى، وينظر إلى نفسه نظرة سلبية، وتكثر تساؤلاته: لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ والحق إنَّ الاكتئاب هو أحد الملاجيء النفسية المعروفة التي نلجأ إليها، لكي نحمى أنفسنا من تلك الآلام النفسية، التي غالباً ما تُصاحب أي اضطراب عاطفيّ، وعبثاً يحاول إنسان أن ينصح المكتئب بألاَّ يحزن، إنَّه نصح مرفوض، لأنَّ الإنسان في ضيقاته يجد في الحزن عزاء له!
ولا يقتصر الاكتئاب على من يعيشون في كهوف مظلمة، وقد تحوَّلت منازلهم إلى مستشفى كبير للأمراض النفسية، أو الذين يترددون على أطباء نفسانيين، فمن المعروف أنَّ أي إنسان معرض في أية فترة من حياته للإصابة بالاكتئاب، فضغوط الحياة اليومية والأمراض الجسدية، وفقدان الأقارب والأصدقاء.. كلُّها عوامل تؤدي إلى خفض الروح المعنوية لدى الفرد، وتجعله فريسة للاكتئاب.. نستطيع أن نقول: إنَّ الاكتئاب صرخة صامتة في أعماق الإنسان، تنبهه إلى أنَّ هناك خطأ يجب عليه أن يعالجه!
ليست مبالغة منا إذا قلنا: إنَّ الاكتئاب من أكثر الموضوعات تعقيداً، إلاَّ أنّه ليس خطية، وليس ذنباً أن تشعر أنّك مغموم، ولكن الحكيم هو من لا يدع لمثل هذه الهموم أن تغمر حياته، فيصبح غير قادر على التواصل مع الآخرين، ألم يُعلن السيد المسيح اكتئابه جهراً بقوله: " نَفْسِي حَزِينَةٌ جِدّاً حَتَّى الْمَوْتِ! " (مر34:14).
ولا تتعجبوا إن قلت لكم: إنَّ التفاخر الزائد وحُب الظهور، من مظاهر الاكتئاب عند البعض، فالإنسان في أحيان كثيرة يسعى إلى التظاهر الملفت، من خلال تبذير أمواله على موائد القمار أو الفسح أو السهرات، أو شرب الخمور أو المسكرات... وما هذه الأفعال إلاَّ ملهاة يلجأ إليها الإنسان كتعويض عن السعادة الغائبة!!
وقد ثبت أنَّ المرأة عندما تفقد الحُب والأمان والقبول لدى الآخرين، فإنَّها تقلق ويدعها هذا الشعور المرير إلى التظاهر إمَّا بارتداء الملابس الخليعة أو الفاخرة، بما لا يناسب مستواها، أو التزين بالجواهر بصورة تدعو إلى النقد والسخرية!
هل تعرف أنَّ هناك ما يُعرف بالعطاء المرضيّ؟ إنَّه نوع غريب من العطاء، يدفع بالإنسان إلي مساعدة الآخرين، ليس حُبّاً فيهم أو رغبة في العطاء، ولكن لكي يتعلّق المحتاجون بمن يُعطيهم، فهو حزين ومكتئب وفى أشد الاحتياج لمن يمكث معه، ولكي يجذبهم نحوه أو يربطهم به، يُهاديهم أو يحل مشاكلهم المادية أو يساعد أولادهم.. فإذا خرج من اكتئابه أعتقد أنَّه سوف يتوقف عن مثل هذه الأفعال!
التدين المرضيّ
لا يستطيع أحد أن يُنكر أهمية الدين، ودور الوصية الإلهية سواء في حياتنا النفسية، أو الروحية، أو الجسدية، أليست الوصايا هي التي هذبت البشر، وحوَّلت إنسان الغابة إلى كائن أليف، وديع، يُضحي بنفسه من أجل الآخرين؟!
لكنَّ التدين السليم لا يعرف المظهرية، فإن كانت أعمال الإنسان تُكذّب أقواله، فإنَّ هذا لا يُعد تديّناً إنَّما رياء، فما معنى أن يتكلم إنسان عن إله هو لم يعرفه؟! ويطلب من الناس تطبيق وصايا هو لم يمسّها بإحدى أصابعه؟ أليس خيراً للإنسان أن يُقيم نفسه الساقطة من أن يقيم أمواتاً كما قال أحد الآباء؟!
ما أكثر الذين يتجهون نحو الله، لتتجه الأنظار إليهم! فيكون تدين هؤلاء للتمويه وليس حُبّاً لله! كما أنَّ هناك نوعاً من التدين يأتي نتيجة صدمة عاطفية، وكثيرون يلجاؤون إلى الله مع بداية المرض، فإذا شُفوا عادوا إلى طبيعتهم الأولى! فهل مثل هذه الحيل الاصطناعية يمكن أن نطلق عليها تديناً؟ إنَّها أقنعة يخفى الإنسان وراءها شئ ما، ولهذا فإنَّ المُمارسات الروحية له تكون أشبه بسوط من نار، يجلد ويحرق به نفسه على الدوام!
ألم يقل الله: " هَذَا الشَّعْبَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ بِفَمِهِ وَأَكْرَمَنِي بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَأَبْعَدَهُ عَنِّي " (إش13:29)، فالله لا يريد من الإنسان سوى قلبه، أي حُبّه: " يَا ابْنِي أَعْطِنِي قَلْبَكَ وَلْتُلاَحِظْ عَيْنَاكَ طُرُقِي" (أم26:23)، وهذا الحُب يجب أن يكون في العطاء وكل ممارستنا الروحية، حقاً إنَّ المسيح قال: " تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ وَأَنَا أُرِيحُكُمْ " (مت11: 28)، إلاَّ أنَّ رب المجد يطلب منَّا، أن نأتي إليه طلباً للراحة أو الشفاء، وليس من أجل الرياء، أو المظهرية، أو المُتاجرة باسم الدين!
الغضب
إنَّ أقوى عاطفتين في الإنسان هما: الحُب والغضب، أمَّا الحب فهو عاطفة إيجابية، تحفظ توازن الإنسان واستقراره النفسيّ، في حين أنَّ الغضب الممقوت عاطفة سلبية، مُدمّرة، والحكيم هو من يقاومها وإلاَّ تحوّل إلى أتون يحرق لا الآخرين فقط، بل ونفسه أيضاً، فما أبهظ التكاليف التي يدفعها أولئك المشتعلون غضباً، فمن الناحية النفسية تظهر التكاليف في المرارة التي يسببها الغضب، والتي تدفع بالإنسان إلى القتل.. أتتذكرون قصة قتل قايين لهابيل؟!
ما هو الغضب؟ هو شهوة أو انفعال، كامن في القلب ومهيج على ارتكاب الخطية، أو هو ذلك السلوك الذي يُسمَّى " فشة "، والتي عن طريقها يستطيع الإنسان أن يُعبّر عن مشاعره المكبوتة، فالغضب كالاكتئاب يهدف إلى التخفيف من آلام الفشل أو الغيظ، ولهذا عندما تضطرب عواطفنا يُصاحب حديثنا ارتفاع في الصوت، وإرشارات بالأيدي، وإحمرار الوجه.. التي هي تعبيرات عن حالة الغضب التي نُعاني منها.
ويتوقّف غضب الإنسان على جسامة الموقف الذي أدى إلى اضطراب عواطفه، فإذا كان الموقف مثيراً ازدادت حِِدة الغضب، ولكن أقل كمية من هذا البخور النجس تكفى لتدنيس الإنسان، يكفي في ذم الغضب ما قاله يعقوب الرسول: " غَضَبَ الإِنْسَانِ لاَ يَصْنَعُ بِرَّ اللَّهِ " (يع20:1)، وقد قال أحد الآباء: " ذبيحة الغضوب بخور نجس " ! وسليمان الحكيم يقول: " اَلرَّجُلُ الْغَضُوبُ يُهَيِّجُ الْخِصَامَ وَالرَّجُلُ السَّخُوطُ كَثِيرُ الْمَعَاصِي " (أم22:29).
كثرة العمل
العمل قانون إلهيّ: " بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزاً " (تك19:3)، وكما قال مُعلّمنا بولس الرسول: " إِنْ كَانَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَغِلَ فَلاَ يَأْكُلْ أَيْضاً " (2تس10:3).
فلو كان يكفى لنا أن نتمنى هذا الشيء أو ذاك، حتى نراه موجوداً أمامنا دون القيام بأي عمل يُذكر، لَمَا كان هناك معنى لحياتنا على الإطلاق، وأصبحنا مجرد كائنات ضعيفة إلى أبعد الحدود، وها نحن نتساءل: ما معنى حياة تدور في عجلة الخلاء وليس فيها هدف أو عمل على الإطلاق؟! أليس في مواجهة المصاعب والتجارب.. وملاقاة العوائق ثم محاولة التغلب عليها متعة كُبرى؟! إنَّها متعة الراحة بعد التعب! أو النصرة بعد الجهاد! أو القيام بعد السقوط!
إنَّ كل الأعمال التي نقوم بها هي التي تطبع صورتنا في الوجود، فإن لم نعمل لا يكون لوجودنا هدف أو لحياتنا معنى، والواقع أنَّ كل فعل يقوم به الإنسان ما أن يتم حتى يلتحم بنسيج الأحداث، لكي يصبح جزءاً لا يتجزأ من صميم الوجود، وهو حين يلتحم بنسيج الحياة، فإنّه يحيا في باطنه دون أن يطرأ عليه الفناء، قد تضعّف ضربات الذبذبات المنبعثة منه، ولكن ما حدث لا يمكن لأيّة قوة أن تمحوه من الوجود!
إلاَّ أنَّ كثرة العمل وعدم رغبة الإنسان في العودة إلى منزله ورؤية زوجته أو مقابلة أهله وأصدقائه، ورفضه القيام بواجباته نحو أُسرته.. تعد من أخطر الوسائل الهروبية أو الحيل الاصطناعية، التي يخفى الإنسان وراءها اضطرابه العاطفي، أو عدم استقراره النفسيّ!
إنَّ كثيرين يعملون وكأنّهم من خلال عملهم يحاولون الهرب من شيء، أو تعويض نقص ما في شخصياتهم، فما أكثر الذين يعملون لكي تزداد ثرواتهم أو ممتلكاتهم، على أمل أن يسترعوا انتباه الآخرين ويحظوا باهتمامهم، فالعديد من هؤلاء يرون في الممتلكات امتداداً لإشباع ذواتهم الناقصة، إنَّه قناع سميك من الأقنعة الكثيرة، التي يرتديها الإنسان عندما يفشل أو تضطرب عواطفه!
الإدمـان
كل الخيارات السابقة التي ذكرناها، هي بدائل عن الإقرار بالفشل، أو الاضطراب العاطفيّ، أو الشعور بالرفض وعدم التقدير.. وهى تساعد الإنسان على التخفيف من الألم أو تخفيه، ولكن دون أن تقضى عليه نهائياً! وهذا الألم الذي يقلق الكثيرين قد يدفعهم إلى مسكّن آخر ألا وهو: الإدمان، فكثيرون لا يقدرون على التكيف، فيبنون لأنفسهم عالماً خاصاً في الداخل، وتصبح الغيبيات هي البحر الذي يسبحون فيه، والارتداد للوراء هو الطريق الأمثل.
وبدلاً من معالجة أمراض الحاضر، ينبشون في الماضي التليد، مادام الحاضر لا يجوز إصلاحه، فيتحوّل هذا الحاضر إلى ماضٍ مع أنهم يُحبونه! إنَّه إعلان واضح وصريح بالفشل في الحياة ! وسواء لجأ الإنسان إلى هذا الأُسلوب عن وعى أو لا وعى، بحثاً عن عالم أفضل جديد، يشعر فيه بالحُب والحماية، إلاَّ أنَّه سوف يعانى من تصرفه هذا، لأنَّه سيظل كالطفل الذي يحيا في عالم الخيال لكي يحمى فيه نفسه أثناء ساعات الخوف.
ومن أبرز مظاهر العيش في عالم الوهم أو الخيال، هو تعليق صور الفتيات الجميلات في حجرات المعسكرات، فهذا دليل واضح على أنَّ الجنود لم يقدروا أن يُشبعوا رغباتهم في عالم الواقع، فراحوا يلتمسون ذلك في عالم الخيال! والحق إن الإدمان من أخطر المآسي، لأنَّه يهلك النفس والجسد كليهما، ومما يُضاعف من تلك المأساة أنَّ المدمن يعيش هارباً من الحياة، وكأنَّه عبر جسراً من عالم الواقع إلى عالم الخيال وأحرق الجسر وراءه!
ولكن لماذا يدخل الإنسان بنفسه تلك الدائرة الجهنمية؟ قد تكون النشوة أو التسلية.. إلاَّ أنَّ ضغوط الحياة والاضطراب العاطفيّ وكثرة المشاكل... عوامل تدفع بالإنسان إلى الإدمان من أجل نسيان الواقع الأليم!
ولو تأمّلنا شخصية المدمنين لوجدنا أن هناك الشخصية غير الناضجة، التي لا يستطيع صاحبها الاعتماد على نفسه، كما يعجز عن تكوين علاقات ثابتة مع الآخرين..
وهناك الشخصية الذاتية، التي يصر صاحبها على تحقيق كل ما يريده في الحال ولو بطرق خاطئة، ويؤدي الإفراط في تدليل الطفل إلى استمرار هذه السمات في شخصيته عند الكِبر.
ولا ننسى المعتل جنسياً، وهو إنسان يعانى من ضعف جنسي، أو الخجل الشديد من الجنس، أو الشذوذ الجنسي، فيلجأ إلى الإدمان حتى يزيل الموانع والضوابط التي فرضها المجتمع!
شخصية أُخرى تُقدمْ على الإدمان، وهى شخصية تجد اللذة في عقاب الذات، نتيجة لشعور دفين بالذنب أمَّا الشخصية القلقة، فإنَّها تلجأ إلى المسكرات لتسكين القلق، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الإدمان!
وهناك الشخصية السيكوباتية " ضد المجتمع "، وهى تملك ميول منذ الطفولة إلى تدمير المجتمع عن طريق تدمير أفراده، وتتصف هذه الشخصية بالنصب والاحتيال والكذب.. ويزيد على ذلك الميل إلى الانحرافات سواء عن طريق الإدمان أو الجنس..
وأيضاً المريض المكتئب الذي يتملكه اليأس، ويرى الحياة أمامه مُظلمة وغير مُشرقة، يُحاول أن يتناول ما يُنسيه هذه الآلام.
كما أن المريض العقلي الذي يعانى من هلاوس وخيالات غير واقعية، يلجأ في مواقف كثيرة إلى المُخدَّرات لتهدئة هذه الأعراض..
من كل هذا يمكن القول: إنَّ السمات التي تتوافر في المدمنين هي الآتي:
التركيز على اللذة عن طريق الفم.
عدم النضوج الجنسي.
الميل إلى عقاب أو تدمير الذات.
الاكتئاب أو الاضطراب العاطفي.
وهذا يفسر لنا سبب انتشار الإدمان بين المراهقين الذكور، فالهدف هو تسكين المشاعر الجنسية وتهدئة العواطف المضطربة، كما أن المراهق يشعر بخيبة أمل كبيرة، نظراً للاضطرابات التي تحدث في المجتمع، وعدم وضوح الرؤيا بالنسبة للمستقبل، وتجاهل أمانيه.. وهذه تدفع به إلى القلق والاغتراب وعدم الاطمئنان، مما يؤدى به إلى الانحراف وخروج عن المجتمع، الذي نبذه وتكوين جماعات مدمنة !
ولَعَلَّ أهم أخطار الإدمان أنَّه يدفع بالشخص إلى القتل، فمن المعروف أنَّ المدمن يريد أن يحصل على المادة المخدرة بأي ثمن، ومن هنا تأتى الجريمة والسرقة والنصب..












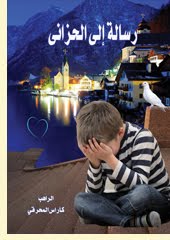






















































































































ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق